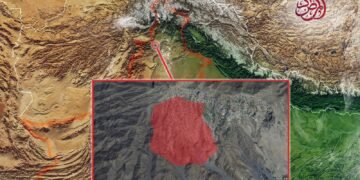لم يكن التدفّق غير المسبوق لشباب الدول الغربية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة داعش ظاهرةً بسيطة أو عفوية، بل كان عملية اجتماعية ونفسية معقّدة، تضرب جذورها في أزمات عميقة تتعلّق بالهوية والثقافة والبنية الاجتماعية داخل المجتمعات الغربية. فبين عامي 2014 و2017، توجّه أكثر من أربعين ألف شخص من أكثر من 110 دول إلى سوريا والعراق للانضمام إلى البنية المتطرّفة لتنظيم داعش.
وكان معظم أفراد هذه الجماعة من فئة الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاماً، غير أنّ صفوفها ضمّت أيضاً رجالاً ونساءً متعلّمين، وأشخاصاً يعانون من اضطرابات نفسية، بل وحتى مجرمين سابقين. ويكشف هذا التنوع البشري والاجتماعي أن قوة جذب داعش لم تكن قائمة على الشعارات الدينية وحدها، بل نجحت في استقطاب شباب يعانون من فراغ الهوية، ويبحثون عن الشعور بالانتماء، ويحملون نزعات مثالية عمياء.
بالنسبة لكثير من الشباب الذين شعروا في المجتمعات الغربية بالتهميش، وانعدام القيمة، وضياع الهوية، لم يكن الانضمام إلى داعش يُعدّ تراجعاً، بل كان يُنظر إليه بوصفه سبيلاً لاكتشاف معنى للحياة، وإثبات الذات، والهروب من هوية يومية فارغة. وقد تمكّن داعش من ملء هذا الفراغ عبر تقديم هوية بديلة، صُوِّرت فيها التضحية بالنفس، والعنف، والتطرّف في قالب من العظمة والمجد.
واعتمدت الآلة الدعائية لداعش، انطلاقاً من فهم عميق لهذه الثغرات النفسية، استراتيجيات دقيقة وموجّهة لكل فئة من فئات المجتمع. فقد عرضت على الشباب المغامرين صوراً بطولية للمقاتلين المسلّحين، ووعدت النساء اللواتي يعانين من الوحدة والهشاشة بأخوةٍ وأمنٍ ومجتمعٍ ذي قيمة، وروّجت للباحثين عن الهوية أسطورة “العودة إلى الجذور” وإحياء كرامة المسلمين المفقودة.
وقد نُشرت هذه الرسائل عبر مقاطع فيديو احترافية، ومجلات رقمية، ومنصّات التواصل الاجتماعي، واستهدفت بعناية بالغة مواطن الضعف النفسية لدى المتلقّين.
واللافت أن غالبية هؤلاء المقاتلين الأجانب لم تكن لديهم، قبل انضمامهم إلى داعش، أي معرفة جادّة بتعاليم الإسلام الأساسية، بل تعرّفوا إلى الدين من خلال الدعاية المحرّفة التي بثّها التنظيم. ويبيّن هذا الواقع أن جاذبية داعش لم تكن نابعة من عمق ديني، بل من تقديم هوية خيالية، انفعالية، وبديلة.
غير أن الواقع الذي واجهه هؤلاء الشباب في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش لم يكن يشبه مطلقاً الصور المثالية التي رُسمت لهم. فالعديد من النساء الغربيات اللواتي توجّهن إلى سوريا أملاً في حياة “المدينة الفاضلة” سرعان ما وجدن أنفسهن زوجاتٍ ثانيات أو ثالثات للمقاتلين. أما الشباب الذين انضمّوا بدافع المغامرة، فقد أُجبروا على المشاركة في عمليات متطرّفة، ومشاهدة إعدامات وحشية، أو التحوّل هم أنفسهم إلى أدوات للعنف. وبعض الوافدين الجدد الذين تجرؤوا على الاعتراض، سقطوا ضحايا للظلم ذاته الذي جاؤوا للمشاركة فيه.
ومع ذلك، لم يؤدِّ الاصطدام بهذه الحقائق المروّعة دائماً إلى الندم. فقد دفعت آلية “التكلفة الغارقة” النفسية كثيرين إلى الاستمرار في صفوف داعش، رغم مشاهدتهم لجرائمه؛ لأن الاعتراف بالخطأ كان يعني انهيار كل الأحلام والأوهام التي تخلّوا من أجلها عن حياتهم السابقة.
إن ظاهرة المقاتلين الأجانب في داعش أثبتت بوضوح أن الجماعات المتطرّفة قادرة على استغلال الفراغات والضعف داخل المجتمعات الحديثة لتحقيق أهدافها. فقد شكّلت أزمة الهوية في الغرب، وشعور الجيل الشاب بالاغتراب، وعجز الأنظمة التعليمية والاجتماعية عن منح الحياة معنى عميقاً، عوامل أساسية مهّدت لهذا المسار.
وبعد سقوط داعش، أسفر عودة عدد محدود من هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم عن نشوء تحدّيات أمنية واجتماعية جديدة، لا تزال دول غربية عديدة تعاني من تبعاتها حتى اليوم. وفي المحصّلة، شكّلت هذه الظاهرة إنذاراً جدّياً للمجتمعات الغربية، مفاده أن الحضارة المعاصرة، رغم كل تقدّمها المادي، ما زالت عاجزة عن تقديم إجابة مُرضية لعطش الإنسان إلى الهوية والمعنى الروحي.