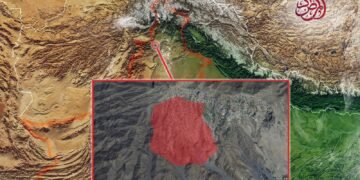في إسطنبول، وأثناء انعقاد المؤتمر السابع لوزراء خارجية الدول الإسلامية، استعرض المجاهد (البروفيسور المهندس نجم الدين أربكان) ماضي التاريخ الإسلامي الذي كانت تمثّله الدولة العثمانية، فقال: إن هذا المكان الذي تُعقد فيه—بفضل الله تعالى وكرمه—هذه القمّة الإسلامية الكبرى، والذي كُتبت على بابه كلمة الإسلام الجامعة للمسلمين، أي: «لا إله إلا الله»، هو المكان الذي بناه محمد الفاتح بعد فتح إسطنبول؛ فكيف لا يكون مكانًا تاريخيًا؟
في هذا المكان كانت تُدار المشاورات المتعلقة بشؤون الإسلام كافة، فكيف لا يكون تاريخيًا، وهو الذي كانت تنطلق منه جيوش الإسلام إلى كل أرجاء العالم تجاهد في سبيل الله تعالى، ناشرةً النور والهداية والعدل حيثما حلّت؟ وكيف لا يكون تاريخيًا، وهذه الصخرة التي وُضع عليها اليوم الميكروفون كانت تُرفع فوقها رايات الجيوش الإسلامية التي كانت تحمي جميع البلاد الإسلامية من الأعداء؟ وأذكر على سبيل المثال بعض الوقائع: فقد اتُّخذ في هذا المكان قرار انطلاق القوة البحرية الإسلامية لإنقاذ إندونيسيا والفلبين من براثن الاستعمار الهولندي. ومن هنا أيضًا أُبرم قرار إرسال الجيوش والقوة البحرية لدعم شمال أفريقيا، لإنقاذها من بطش المحاربين التابعين لأهوائهم.
وأعظم من ذلك كله، أن هذه البناية التاريخية تحتفظ في جدرانها بآثار تذكارية للنبي الكريم ﷺ، ومنها راية النبي ﷺ، وخادمه، وسيفه المبارك، وغير ذلك. وعلى كل حال، كانت الدولة العثمانية تولي مبادئ الجهاد أهمية بالغة، وتُعِدّ الجيوش ابتغاء مرضاة الله تعالى، فكان في ذلك نفع عظيم للإسلام والمسلمين.
وكانت تحافظ على بيت المال من الضياع. فقد كان قادة العثمانيين يرون أن الإمبراطورية مؤسسةٌ تؤدي واجب نشر الأحكام الشرعية، وتمثيل إرادة الأمة، وحماية الثروات الوطنية على الوجه الصحيح. ولم تكن مهمة الإمبراطورية مقتصرة على إقرار الأمن والدفاع فحسب، بل كانت تعتني أيضًا بإصلاح المجتمع، ومنع الإنفاق غير المشروع من بيت المال، وحماية موارده ومداخيله وصادراته.
ولم يكن يُرفع السيف في وجه الرعية إلا حيث يأذن الإسلام بذلك. فوظيفة الدولة هي تنفيذ الأحكام الشرعية، والشريعة تقتضي صيانة أموال الناس. وقد سدّ الإسلام جميع طرق أخذ أموال الناس بغير حق. ومن واجب الحاكم أن يحفظ أموال الأمة من السرقة والنهب، لا أن ينهب أموال الشعب ويبدأ بظلمه.
وكانوا يُعينون المحتاجين بالطعام واللباس والمسكن، ويُجلّون أهل الصلاح. وقد تنافس قادة الدولة العثمانية في الإحسان إلى الفقراء والمساكين، فكان كل من استحق البرّ والإحسان يُبادَر إلى مساعدته. وقد قامت الدولة العثمانية في هذا المجال بأعمال عظيمة، فأنشأت مؤسسات للطلاب والفقراء والأرامل، وكان الزكاة تُعدّ ركنًا أساسيًا من أركان الإمبراطورية.
وقد كتب البروفيسور محمد حرب: «إن الحركة العلمية في جامعات إسطنبول كانت في أوج نشاطها، وقد بذل العالم صوقللي محمد باشا جهودًا كبيرة في هذا المجال، إذ كان ينفق على الحركة العلمية في إسطنبول من عائدات (2000) قرية عثمانية في (التشيك وسلوفاكيا)، إذ كانت تلك المناطق جزءًا من الدولة العثمانية. وكذلك أسعدي أفندي، قاضي جيش البلقان، أنشأ مركزين كبيرين لرعاية الأيتام، وكان يُزوّجهم عند بلوغهم سنّ الزواج زواجًا كريمًا».
وكانت مراكز توزيع الزكاة في الخلافة العثمانية كثيرة جدًا، فمنها مراكز تُصرف من عائداتها رواتب شهرية للأسر المحتاجة، وكانت هذه الرواتب غير مخصّصة للطعام والشراب، لأن للطعام والشراب مراكز أخرى. وقد أُنشئت مبانٍ خاصة لإطعام الفقراء والمحتاجين مجانًا، وكانت هذه المباني قادرة على إطعام نحو (20) ألف شخص في وقت واحد. وكانت هذه الترتيبات موجودة في جميع الولايات.
وكانت هناك أيضًا تكية خيرية من هذا النوع في جامع السليمانية. ففي سنة (1586م) بلغت نفقات هذه التكية ما يقارب عشرة ملايين دولار تقريبًا. وكانت سياسة الدولة، على مستوى القادة والأمراء والوزراء، تقوم على ضمان الطعام والشراب والمأوى للمحتاجين.
وكان يُنظر إلى العلماء على أنهم كالروح في الجسد؛ فيُكرمون وتُرفع هممهم. فإذا بلغ الحاكم خبرُ عالمٍ في مدينة أخرى، دعا به إليه، ولبّى له جميع احتياجاته.