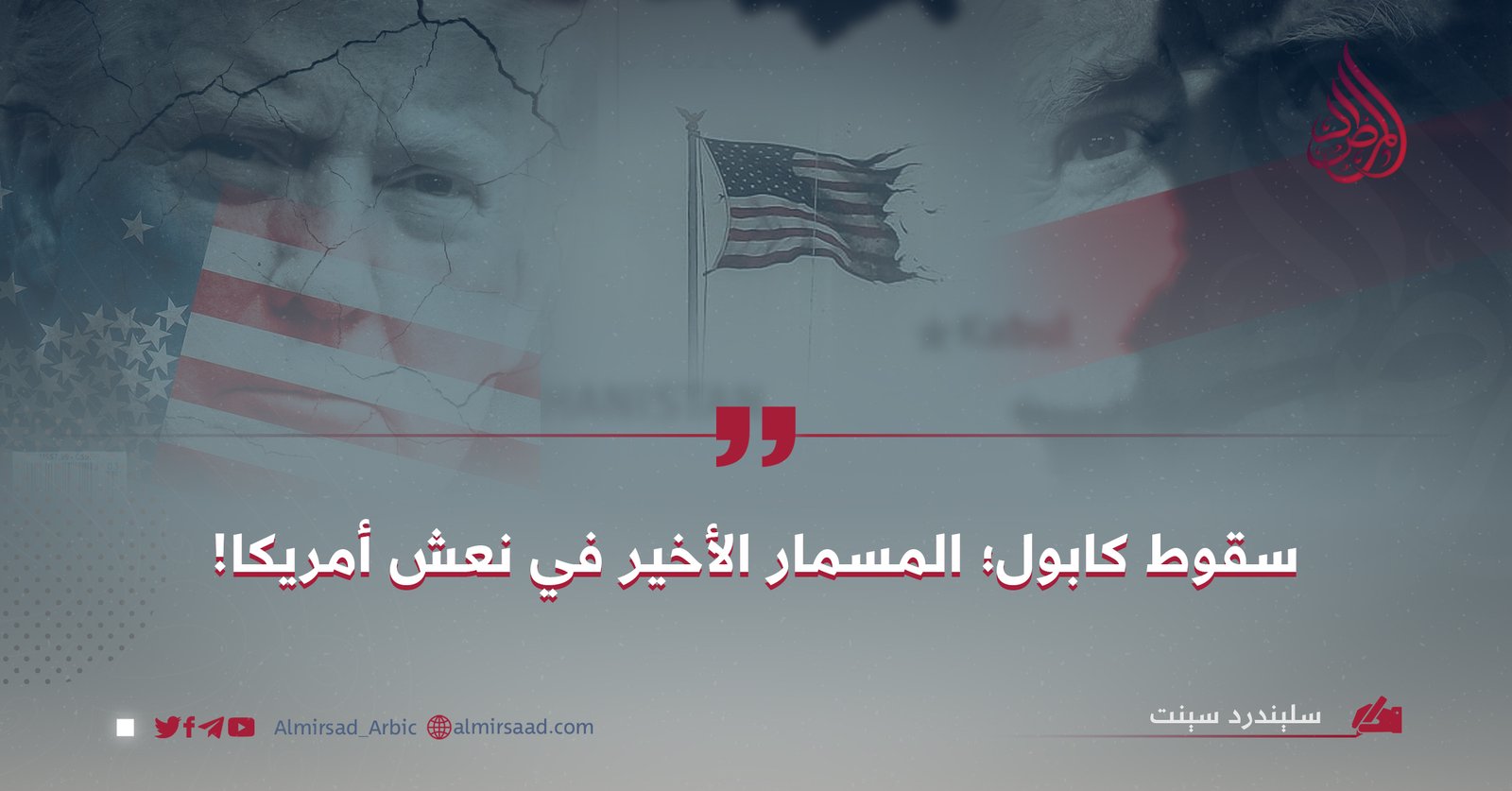لم يكن انهيار إدارة كابول الذي وقع في شهر أغسطس/ عام 2021 فشلا مصادفة لأمريكا؛ بل كان الستار الأخير لمأساة وبؤس طويلين والذي نبتا من جرح جهل أمريكا المتمثل بأحلام أميركية من إخضاع أرض والحكم عليها بقوة الحديد.
قضيتُ سنوات في جهاز الاستخبارات، ورأيتُ بأم عيني كيف تفاقم تنامى هذا العمى يوما بعد يوم، وكيف كانت السياسات مبنية على أوهام مُريحة بدلاً من الحقائق، كنا نؤمن أننا نتمكن من تحطيم العقيدة بالقوة، وأن المعتقدات البشرية ستستسلم تحت وطأة القنابل، لكن كنا مخطئين – مخطئين تماماً !
بعد أحداث 11 سبتمبر/ كنا نعزي أنفسنا بالقول إن الهجمات كانت نتيجة كراهيةِ غير عقلانية. ولم نكن على استعداد لقبول أن مخططي هجمات الحادي عشر من سبتمبر لم يشعروا فقط أنهم على الصواب والطريق الصحيح بل آمنوا
أن ذلك من واجبهم، وأنهم يؤدون الحكم الإلهي المتمثل بجهاد دفاعي والذي نتج من عدوان عسكري أميركي وعقوباتها الجائرة وانتهاكها الأماكن الإسلامية المقدسة.
لم ينظروا إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر من منظور عمل عشوائي بل شكل آخر من المقاومة، سواءً أدركنا هذا المنطق أم لا، ليس له أي أهمية.
عدم تغاضيا من أخذ رؤيتهم للعالم على محمل الجد كفل لنا تكرار نفس السيناريوهات التي أنتجت هذه الردود العنيفة.
لن أنسى ما حييتُ تلك اللحظة التي أُبلغ فيها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد مام عيني بخبر رفض الملا محمد عمر تسليم أسامة بن لادن، احمر وجهه واستشاط رامسفيلد غضباً وضرب بمرفقه على الطاولة وصرخ بغضب قائلا:
“لماذا هذا الرجل عنيد إلى هذا الحد؟ لماذا هؤلاء الناس تجاوزا حدود العقل ؟
ثم حدق بي، وأنا كنت ضابطا شابا كالبقية واقفا لزمتُ الصمت من هول الصدمة لحضوري في هذا الاجتماع الثقيل وصرخ في وجهي بصوت عال:
“حسناً، ما هو جوابك؟ كم قنبلة يجب أن نلقي على عمر لحفر عناد هذا الرجل.
وقفت هناك، وأنا بين الخوف والاحترام، قلبي يخفق بشدة، لكنني استجمعت القوى وقلت الكلمة الوحيد التي أعرفها:
سيدي، كلما ألقينا عليه المزيد من القنابل، زادت عزيمته.
«رامسفيلد» الذي كان قد أدار ظهره، استدار فجأة كالرعد، وألقى على الطاولة ملفًا ثقيلًا مملوءًا بالوثائق، ارتطم بهدوء على سطح المكتب؛ وإن لم يكن يقصد إصابة أحد، إلا أنني اضطررت لأن أحني رأسي لأتجنب الضربة. في تلك اللحظة، بدت هذه المشهدية واحدة من تلك المشاهد العنيفة الكثيرة التي اعتدنا عليها من قبل، لكن لاحقًا، حين خرجت الحرب شيئًا فشيئًا عن سيطرتنا وتكشّفت الحقائق، أدركتُ أي سرٍّ كبيرٍ كانت تخفيه تلك اللحظات.
في ذلك القصر الذي اجتمع فيه جبابرة القوة العظمى في العالم، لم نكن ندرك شيئًا عن طبيعة تلك الحرب التي خضناها بغير روية ولا تدبير. كان رفض الملا عمر ليس ضربًا من الجنون، بل التزامًا شرعيًا بواجب دينيّ، ولا سيما في ثقافة الأفغان التي ترى أن خيانة من لجأ إليك ولاذ بحماك جريمةٌ لا تُغتفر.
إن الدفاعَ الجهادي أمام الغزاة الأجانب ليس خيارًا اختياريًا، بل هو فرضٌ دينيٌّ صريح، وعندما وطأت أقدام الجنود الأمريكيين أرض أفغانستان، لم يعد خيار المقاومة مجرّد احتمال، بل صار أمرًا حتميًّا لا بديل عنه.
وكلما وسّعنا رقعة الحرب أكثر، وكل قنبلةٍ أسقطناها عليهم، كان ذلك يزيد من عمق إحساس الأفغان بواجبهم الديني ويؤجّج نار المقاومة أكثر فأكثر.
في داخل الـ «سي آي إيه» كنا نحسب عدد القتلى، وعدد الولايات «الآمنة»، وعدد الدولارات التي أُنفقت؛ لكن طالبان لم تكن تقاتل من أجل أرضٍ أو مالٍ أو سلطة، بل من أجل الوفاء، كانت تقاتل لأجل الله، لأجل العزّة، ولأجل وطنهم.
كانوا يقاتلون لأن إيمانهم يأمرهم بذلك، ولأن استمرار الصبر والثبات في حد ذاته شكلٌ من أشكال النصر. لقد أخطأنا حين ظننا أن انضباطهم الصارم هو تطرّفٌ يمكن كسره بمزيدٍ من العنف، كنا نعتقد أنه إذا ما زدنا من ضغطنا، وألقينا المزيد من الأسلحة، وأنفقنا المزيد من الأموال، فإنهم سيرضخون لنا أخيرًا، لكننا كنا واهمين أشدّ الوهم؛ فكلما اشتدّ ضغطنا، ازدادت إرادتهم صلابةً وقوة.
لقد انتصر أفغانستان وصبر شعبه لأنه لم يكن قويًا بالسلاح وحده، بل لأن في قلوب أهله ما يزال يعيش ذلك الإيمان بأن الحياة ليست للبقاء فحسب، بل إن هناك أشياء أثمن من البقاء نفسه.
وفشلت أمريكا لأنها نسيت أن مثل هذه القناعات ما تزال حيّة، وأنه لا يمكن لأي إمبراطورية مهما بلغت من القوة أن تقتل هذا الإيمان بالقنابل أو الأموال أو الشعارات. وما لم تدرك أمريكا هذه الحقيقة، فإن كل تدخلٍ قادمٍ لها سينتهي بالعار والتعب والهزيمة ذاتها.