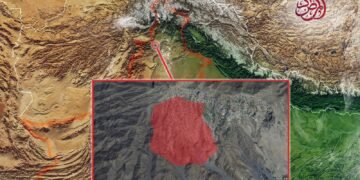الشريعة المزيّفة (تحليل الأداة الفقهية المحرَّفة لدى داعش)
2- التحريف في فروع الأحكام
إن النتيجة الطبيعية للمنهج المحرَّف لدى داعش—الذي جرى بحثه في المقالات السابقة—تمثّلت في بروز جملة من الأحكام التي اتخذت في ظاهرها شكلًا إسلاميًا، لكنها في حقيقتها لا تمتّ بصلة إلى الفقه الإسلامي الأصيل. وهذه الأحكام لم تكن فقط غير مسبوقة في تاريخ الإسلام، بل جاءت في تعارضٍ صريح مع روحه الجوهرية التي تؤكد حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
في الواقع، كانت هذه الأحكام المحرَّفة أدواتٍ لتبرير العنف المنظَّم وترسيخ سلطةٍ تقوم على الخوف والظلم.
ويمكن دراسة هذه الأحكام ضمن أربعة محاور أساسية. وأولها—وهو الأخطر—التكفير الواسع والشامل. فمن المبادئ الراسخة في الفقه الإسلامي أن المسلم لا يُكفَّر لمجرّد ارتكاب معصية أو لاختلاف فقهي أو سياسي. وقد صيغت هذه القاعدة بقولهم: «لا نُكفِّرُ أحدًا من أهلِ القِبلةِ بذنب» أي لا يُحكم بكفر المسلم لمجرّد الذنب أو الخلاف الفقهي والسياسي.
غير أن داعش تجاهلت هذا الأصل تجاهلًا تامًا، وقدّمت تعريفاتٍ ضيّقة ومصطنعة ومتطرّفة لـ«التوحيد» و«الشرك»، حتى ضيّقت دائرة الإسلام إلى حدّ لم يعد يتّسع إلا لأفراد جماعتها. وبناءً على هذا التصوّر، كُفِّر جميع المسلمين المخالفين لهم: من أهل السنّة المخالفين، والصوفيين، وسكّان الدول الإسلامية، بل وحتى جماعات جهادية أخرى، واعتُبروا مرتدّين.
عمليًا، كان معنى هذا الحكم إباحة قتل هؤلاء جميعًا ونهب أموالهم. وبعبارة أخرى، شكّل هذا الحكم غطاءً دينيًا للإبادة والنهب، وأحدث أعمق شرخٍ في جسد الأمة الإسلامية، وأحلّ دماء المسلمين باسم الدين.
أما التحريف الثاني فتمثّل في إحياء العبودية المنظَّمة، وهو من أبرز ممارسات داعش. ففي العالم المعاصر، أجمع علماء الإسلام المعتبرون—في ضوء المقاصد الأخلاقية للدين والتحوّلات العالمية—على أن الرقّ منسوخ وغير مقبول.
لكن داعش تجاهلت هذا الإجماع الفقهي الواسع، وأقدمت بصورة منظَّمة على استرقاق النساء والأطفال من الأقليات، ولا سيما الإيزيديين، ومارست بحقهم الاستغلال الجنسي. وكانت تستند انتقائيًا إلى بعض آيات الجهاد دون مراعاة للسياق التاريخي والظروف والملابسات، لتبرير ممارساتها الوحشية.
في الحقيقة، شكّلت هذه الأفعال نوعًا من التطهير العرقي والجنسي، لم يكن هدفه إذلال الضحايا فحسب، بل محو الهوية الاجتماعية لمجتمعٍ كامل. وكان هذا السلوك على تعارضٍ تام مع سيرة النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، الذين تعاملوا مع الأسرى بمنطق الرحمة والكرامة الإنسانية.
أما التحريف الثالث الخطير فكان إلغاء مبدأ العدالة الفردية وتطبيق العقوبات الجماعية. وقد نصّ القرآن الكريم بوضوح: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
(لا تحمل نفسٌ وزر نفسٍ أخرى). لكن داعش تجاهلت هذا الأصل، وعاقبت عائلاتٍ وقبائلَ كاملة، بل سكّان مناطق بأسرهم، بجريرة أفعال فردٍ أو أفراد. فهدم البيوت، والإعدامات الجماعية، وحصار المدن، كلها مظاهر لعرف «المسؤولية القبلية» الجاهلي الذي جاء الإسلام لإبطاله. ولم تكن هذه السياسة انتهاكًا للعدالة فحسب، بل تصادمًا صارخًا مع أسس الأخلاق الإسلامية.
أما العلامة الرابعة على اغتراب داعش العميق عن الحضارة الإسلامية فكانت التدمير المنهجي للآثار التاريخية والثقافية. فهدم مدينة تدمر التاريخية في سوريا، وتخريب أضرحة الأنبياء والأولياء، وتدمير المساجد التاريخية، لم يكن له أي مسوّغ فقهي معتبر. لقد كان ذلك عدوانًا ثقافيًا هدفه محو هوية الناس وتاريخهم وذاكرتهم الجمعية، ليبقى فقط سرد داعش. وهذا السلوك يتناقض كليًا مع سيرة خلفاء صدر الإسلام الذين حافظوا حتى على المباني غير الإسلامية.
إن هذه التحريفات الأربعة الكبرى—التكفير الواسع، وإحياء العبودية، والعقوبات الجماعية، وتدمير التراث الثقافي—لم تكن نتاج فهمٍ صادق للدين، بل ثمرة برنامجٍ سياسي وعسكري مُسبق. ففي هذا البرنامج قُدِّمت أهدافٌ محددة سلفًا—كإقصاء الخصوم، والسيطرة على الناس، وبثّ الرعب، وتوسيع النفوذ—على غيرها، ثم استُخدمت النصوص الدينية بصورة انتقائية ومحرَّفة لتبرير تلك الأهداف.
وعليه، لا يمكن عدّ هذه الأحكام اجتهادًا شرعيًا، بل أدواتٍ أيديولوجية لبلوغ السلطة، استُخدم فيها اسم الدين لإخفاء المقاصد الحقيقية. إن فهم هذا الآلية ذو أهمية حيوية في مواجهة مثل هذه الجماعات؛ لأن المواجهة ليست عسكرية فحسب، بل تشمل أيضًا استعادة المعاني الحقيقية والأصيلة للدين، وتحريرها من قبضة المحرِّفين.