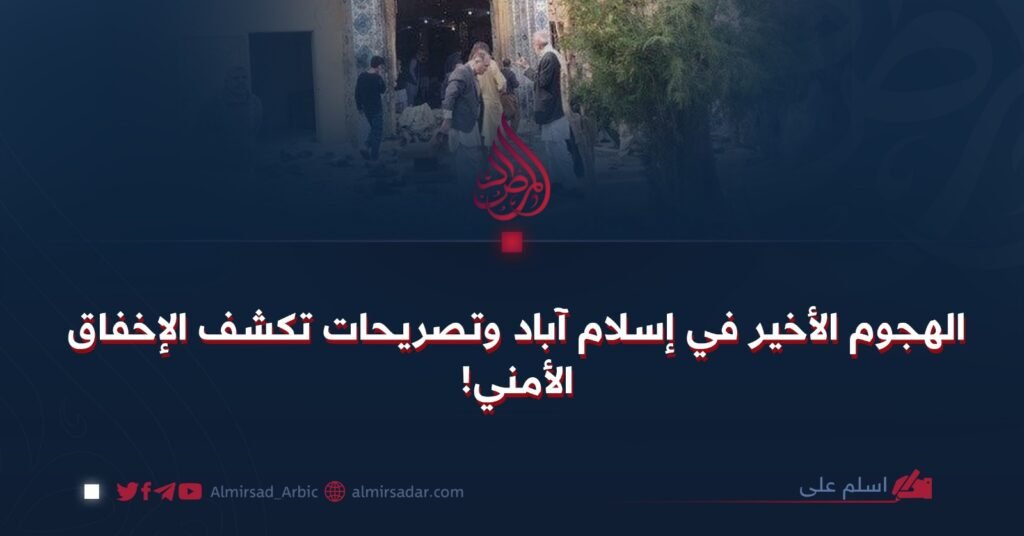في السادس من فبراير من هذا العام، فجرَ انتحاريٌ نفسه داخل مسجد خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وإصابة نحو 170 آخرين. هذا الهجوم، الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، لا يُعد مجرد فصل جديد من فصول العنف ضد الأقلية الشيعية فحسب؛ بل يكشف أيضًا عن ثغرات عميقة في إدارة الحكومة الباكستانية للملف الأمني.
هذا التفجير، الذي يُعد الأعنف في إسلام آباد خلال السنوات العشر الأخيرة، يمثل مثالًا واضحًا على الإخفاق في السياسات الداخلية والخارجية للدولة. ويأتي في وقت تدعي فيه باكستان منذ سنوات أنها تكافح الإرهاب، لكن استمرار مثل هذه الهجمات يوضح بجلاء أن مؤسسات الدولة لا تزال عاجزة عن حماية المواطنين حتى في قلب العاصمة. المسجد، الواقع في منطقة ترلاي كلان جنوب شرق إسلام آباد، كان هدفًا مباشرًا للمهاجم أثناء أداء صلاة الجمعة.
وبحسب الشرطة، فقد حاول الحرس الأمنيون إيقاف المهاجم عند باب المسجد، لكنه تمكن مع ذلك من تفجير سترته الناسفة. وهذا لا يمثل فقط تجددًا للعنف الطائفي ضد الشيعة، بل أدى أيضًا إلى إثارة حساسيات داخلية واسعة في البلاد.
لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا تعجز الحكومة الباكستانية عن منع مثل هذه الهجمات؟ ففي الوقت الذي كانت فيه جثث الضحايا والجرحى متناثرة في موقع الانفجار، سارعت المؤسسات الباكستانية—وعلى رأسها وزير الداخلية محسن نقوي ووزير الدفاع خواجه آصف وبعض المصادر الأمنية—إلى الادعاء بأن الهجوم خُطّط له في أفغانستان، وأن الانتحاري تلقّى تدريبه هناك، وأن أربعة من مساعديه (من بينهم متهم رئيسي أفغاني الجنسية) قد تم اعتقالهم في بيشاور ونوشهره بناءً على “معلومات فنية وبشرية”.
غير أنّ هذه الادعاءات قوبلت بردود فعل غاضبة من الشارع الباكستاني والمعارضة وحتى من مسؤولين حكوميين. فقد رأى المواطنون أن هذه الاعتقالات جاءت كردّ فعل بعد وقوع الحادث، لا كخطوة وقائية، وتساءلوا: إذا كانت الأجهزة الأمنية تمتلك كل هذه المعلومات، فلماذا لم تمنع الهجوم في العاصمة؟ كما وصفت منظمات الشيعة—مثل مجلس وحدة المسلمين—هذه الادعاءات بأنها ضعيفة، مؤكدة أن الحكومة لا تتخذ إجراءات جدية ضد العنف الطائفي، بل تكتفي باعتقالات لاحقة لتهدئة الغضب الشعبي. وفي الاحتجاجات التي خرجت في كُرغيل، مَتلي وغيرها، انتقد المتظاهرون فشل الحكومة قائلين: “إذا كانت العاصمة غير آمنة، فكيف ستكون بقية المناطق؟”.
أما أحزاب المعارضة فقد اعتبرت تصريحات محسن نقوي محاولة لإخفاء فشل الحكومة، مؤكدين أن الوزير وحكومته “يكتفون بالكلام” ولا يقرّون بالإخفاق الأمني الحقيقي—خصوصًا فشل الاستخبارات (ISI) والشرطة. فيما قال آخرون إن الاعتقالات تهدف لتحقيق “نقاط سياسية” لا لتحقيق العدالة، إذ لم تُقدَّم حتى الآن أي أدلة تفصيلية حول المتهمين.
من جانبها، نفت وزارة الدفاع في إمارة أفغانستان الإسلامية هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا، ووصفتها بأنها محاولة من باكستان لإخفاء فشلها الأمني.
خلاصة القول: هذا الهجوم يكشف ثغرات عميقة في المنظومة الأمنية الباكستانية. أولًا، وقوعه داخل إسلام آباد—التي يفترض أن تكون أكثر مناطق البلاد أمنًا—يدل بوضوح على عجز الشرطة والاستخبارات عن أداء مهامهما. فعلى الرغم من حديث الحكومة عن “نجاحات” في مكافحة داعش خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا الهجوم يؤكد أن التنظيم لا يزال نشطًا، وأن الدولة غير قادرة على القضاء عليه بالكامل. داعش، الذي يُعرف بعدائه الأيديولوجي للشيعة، استغل هذا الهجوم لإظهار بقاءه وقدرته على العمل.
ثانيًا، الحادثة تكشف ضعفًا في سياسة باكستان الخارجية أيضًا. فاعتقال أربعة متورطين بعد الهجوم لا يُعد إلا خطوة متأخرة. وهذا يدل على أن الحكومة لا تعتمد على المعلومات الاستخباراتية بشكل استباقي، بل تتحرك فقط بعد وقوع الكارثة. كما أن هذا الضعف ليس أمنيًا فحسب، بل سياسيًا أيضًا. فباكستان، التي تواجه تحديات اقتصادية وبطالة واسعة، لا تمتلك سياسة وطنية موحدة لمكافحة الإرهاب. حماية الأقلية الشيعية، التي تتعرض باستمرار لهجمات طائفية، لا تبدو أولوية للحكومة. وقد أدى هذا الهجوم إلى إثارة توترات طائفية داخلية قد تمهد لمزيد من العنف.
في النهاية، يمثل هذا التفجير إنذارًا صريحًا للحكومة الباكستانية بضرورة تقوية منظومتها الأمنية، وتفعيل مؤسساتها الاستخباراتية، واعتماد موقف حاسم ضد داعش—لا أن تُحمِّل الآخرين مسؤولية أخطائها. فاستمرار هذه الهجمات لن يهدد استقرار باكستان وحدها، بل سيضرّ بثقة المنطقة والجيران بها أيضًا. وعلى باكستان أن تعطي أولوية لأمن مواطنيها، لا أن تكتفي بالإدانات أو تُلقي اللوم على الآخرين بعد كل حادثة.
الهجوم الأخير في إسلام آباد وتصریحات تکشف الإخفاق الأمني!
أسلم علي